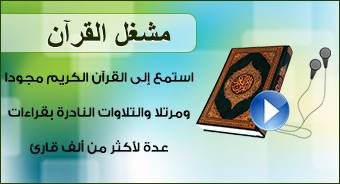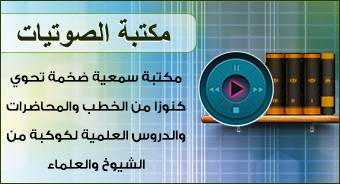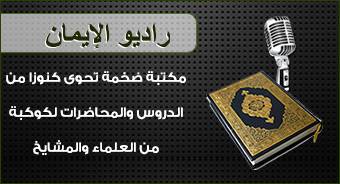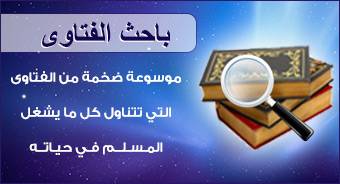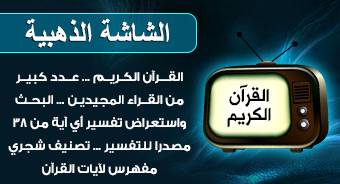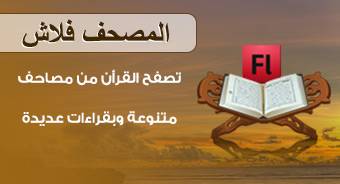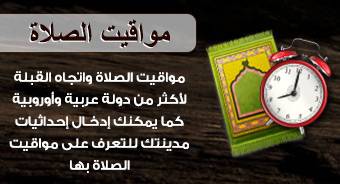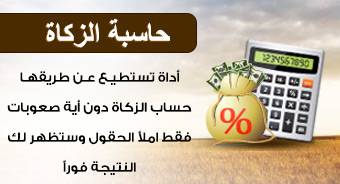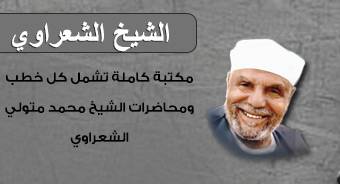|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا (نسخة منقحة)
المرتبة الثانية: أن يختص التوازن بالكلمتين الأخيرتين من الفقرتين فقط دون ما عداهما من سائرالألفاظ، كقوله تعالى: {فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة} ثم قال: {ونمارق مصفوفة * وزرابي مبثوثة}. وكقول الحريري في مقاماته: ألجأني حكم دهر قاسط، إلى أن انتجع أرض واسط. وقوله: وأودى الناطق والصامت، ورثي لنا الحاسد والشامت، وما أشبه ذلك.المرتبة الثالثة: أن يقع الاتفاق في حرف الروي مع قطع النظر عن التوازن في شيء من أجزاء الفقرة في آخر ولا غيره، ويسمى المطرف، كقوله تعالى: {ما لكم لا ترجون لله وقاراً * وقد خلقكم أطواراً} وقولهم: جنابه محط الرحال، ومخيم الآمال. وما يجري هذا المجرى.الصنف الثاني أن يختلف حرف الروي في آخر الفقرتين وهو الذي يعبرون عنه بالازدواج. والرماني يسميه السجع العاطل، وعليه كان عمل السلف من الصحابة ومن قارب زمانهم، وهو على ضربين:الضرب الأول أن يقع ذلك في النثر وفيه مرتبتان:المرتبة الأولى: أن يراعي الوزن في جميع كلمات القرينتين أو في أكثرها مع مقابلة الكلمة بما يعادلها وزناً، ويسمى التوازن وهو أحسنها وأعلاها، كقوله تعالى: {وآتيناهما الكتاب المستبين * وهديناهما الصراط المستقيم} وكقول الحريري: اسود يومي الأبيض، وأبيض فودي الأسود.المرتبة الثانية: ألا يراعى التوازن إلا في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين فقط، ويسمى التوازن أيضاً، ومنه قوله تعالى: {ونمارق مصفوفة * وزرابي مبثوثة} وقولهم: اصبر على حر القتال، ومضض النزال، وشدة النصاع، ومداومة البراز، وما أشبه ذلك.الضرب الثاني السجع الواقع في الشعر ويسمى التصريع في البيت الأول، ومحل الكلام عليه علم البديع، وقد ذكره في المثل السائر في أعقاب الكلام على السجع في الكلام المنشور، وجعله على سبع مراتب:المرتبة الأولى: وهي أعلاها درجة، أن يكون كل مصراع من البيت مستقلاً بنفسه، غير محتاج إلى ما يليه؛ ويسمى التصريع الكامل، كقول امرئ القيس: فإن كل مصراع من البيت مفهوم المعنى بنفسه، غير محتاج إلى ما يليه في الفهم، وليس له به ارتباط يتوقف عليه.المرتبة الثانية: أن يكون المصراع الأول مستقلاً بنفسه، غير محتاج إلى الذي يليه إلا أنه مرتبط به، كقول امرئ القيس أيضاً: فإن المصراع الأول منه غير محتاج إلى الثاني في فهم معناه، ولكنه لما جاء الثاني صار مرتبطاً به.المرتبة الثالثة: أن يكون الشاعر مخيراً في وضع كل مصراع موضع الآخر، ويسمى التصريع الموجه، كقول ابن حجاج: فإنه لو جعل المصراع الثاني أولاً والآخر ثانياً، لساغ له ذلك.المرتبة الرابعة: أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه، ولا يفهم معناه إلا بالثاني؛ ويسمى التصريع الناقص، وليس بمستحسن، كقول المتنبي: فإن المصراع الأول لا يستقل بنفسه في فهم معناه دون المصراع الثاني.المرتبة الخامسة: أن يكون التصريع في البيت بلفظة واحدة في الوسط والقافية، ويسمى التصريع المكرر؛ ثم اللفظة التي يقع بها التصريع قد تكون حقيقة لا مجاز فيها كقول عبيد بن الأبرص: وقد تكون اللفظة التي يقع بها التصريع مجازية كقول أبي تمام الطائي: المرتبة السادسة: أن يكون المصراع الأول معلقاً على صفة يأتي ذكرها في أول المصراع الثاني؛ ويسمى التصريع المعلق. كقول امريء القيس: فإن المصراع الأول معلق على قوله بصبح، وهو مستقبح في الصنعة.المرتبة السابعة: أن يكون التصريع في البيت مخالفاً لقافيته؛ ويسمى التصريع المشطور، وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها. كقول أبي نواس: فإنه قد صرع في وسط البيت بالباء ثم في آخره بالدال.قلت: وإنما أوردت هذا الصنف مع السجع وإن كان من خصوصيات الشعر لأنه قد يقع مثله في النثر، إذ الفقرة من النثر كالبيت من الشعر، فالفقرتان كالبيتين، وأيضاً فإن الشعر من وظيفة الكاتب.الغرض الرابع في معرفة مقادير السجعات في الطول والقصر وهي على ضربين:الضرب الأول السجعات القصار وهي ما صيغ من عشرة ألفاظ فما دونها، قال في حسن التوسل: وهي تدل على قوة التمكن وإحكام الصنعة، لا سيما القصير منها للغاية، وأقل ما يكون من لفظتين كقوله تعالى: {يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر}. وقوله: {والمرسلات عرفاً * فالعاصفات عصفاً} وما أشبه ذلك، وأمثاله في القرآن الكريم كثير إلا أن الزائد على ذلك أكثر. كقوله تعالى: {والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى}. وقوله: {اقتربت الساعة وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر * وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر}. وقوله: {وقالوا اتخذ الرحمن ولداً * لقد جئتم شيئاً إدا * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً} ونحو ذلك.الضرب الثاني السجعات الطوال قال في حسن التوسل: وهي ألذ في السمع، يتشوق السامع إلى ما يرد متزايداً على سمعه، وأقل ما تتركب من إحدى عشرة كلمة فما فوقعها، وغالب ما تكون من خمس عشرة لفظة فما حولها، كقوله تعالى: {وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور} فالأولى من إحدى عشرة لفظة، والثانية من ثلاث عشرة لفظة، قوله: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم} فالأولى من أربع عشرة لفظة، والثانية من خمس عشرة، وقوله: {إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور * وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور} فالأولى عشرون لفظة، والثانية تسع عشرة، وهذا غاية ما انتهى إليه الطول في القرآن الكريم. وينبغي أن يكون ذلك نهاية الطول في السجع وقوفاً مع ما ورد به القرآن الكريم الذي هو أفصح كلام، وأقوم نظام، وإن كان الوزير ضياء الدين بن الأثير، والشيخ شهاب الدين محمود الحلبي وغيرهما، قد صرحوا بأنه لا ضابط لأكثره.واعلم أنه قد جرت عادة كتاب الزمان ومصطلحهم أن تكون السجعة الأولى من افتتاح الولاية من تقليد أو توقيع أو غير ذلك قصيرة بحيث لا يتعدى آخرها السطر الثاني في الكتابة ليقع العلم بها بمجرد وقوع النظر على أول المكتوب. وعلى هذا فيختلف القصر فيها باختلاف ضيق والورق وسعته في العرض.الغرض الخامس في ترتيب السجعات بعضها على بعض في التقديم والتأخير باعتبار الطول والقصر:وله حالتان:الحالة الأولى: ألا يزيد السجع على سجعتين؛ وله ثلاث مراتب:المرتبة الأولى: أن تكون القرينتان متساويتين لا تزيد إحداهما على الأخرى كقوله تعالى: {فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر}، وقوله: {والعاديات ضبحاً * فالموريات قدحاً * فالمغيرات صبحاً * فأثرن به نقعاً * فوسطن به جمعاً} وأمثال ذلك.المرتبة الثانية: أن تكون القرينة الثانية أطول من الأولى بقدر يسير كقوله تعالى: {بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً * إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً} فالأولى ثمان كلمات، والثانية تسع، ونحو ذلك؛ أما إذا طالت الثانية عن الأولى طولاً يخرج عن الاعتدال، فإنه يستقبح حينئذ، ووجهه في حسن التوسل بأنه يبعد دخول القافية على السامع فيقل الالتذاذ بسماعها. والمرجع في قدر الزيادة والقصر إلى الذوق.المرتبة الثالثة: أن تكون القرينة الثانية أقصر من الأولى. قال في المثل السائر: وهو عندي عيب فاحش، لأن السمع يكون قد استوفى أمده من الفصل الأول بحكم طوله، ثم يجيء الفصل الثاني قصيراً فيكون كالشيء المبتور، فيبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها؛ وفيما قاله نظر، فقد تقدم في قوله تعالى: {إذ يريكهم الله في منامك قليلاً} الآيتين، أن الأولى عشرون كلمة والثانية تسع عشرة، بل قد اختار تحسين ذلك أبو هلال العسكري في الصناعتين محتجاً له بكثرة وروده في كلام النبوة كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: «إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع» وقوله: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم، وهم يد على من سواهم» وقوله: «رحم الله من قال خيراً فغنم أو سكت فسلم».الحالة الثانية أن يزيد السجع على سجعتين، ولها أربع مراتب المرتبة الأولى: أن يقع على حد واحد في التساوي وهو مستحسن، وقد ورد في القرآن الكريم بعض ذلك كقوله تعالى: {وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين * في سدر مخضود * وطلح منضود * وظل ممدود} فهذه السجعات الثلاثة مركبة من لفظتين لفظتين.المرتبة الثانية: أن تكون الأولى أقصر والثانية والثالثة متساويتين كقوله تعالى: {بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذبا بالساعة سعيراً * إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً * وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً} فالأولى من ثمان كلمات، والثانية من تسع تسع.المرتبة الثالثة: أن تكون الأولى والثانية متساويتين، والثالثة زائدة عليهما، وقد أشار إلى هذه المرتبة في حسن التوسل حيث قال: فإن زادت القرائن على اثنتين فلا يضر تساوي القرينتين الأوليين وزيادة الثالثة، ولم يمثل لها.المرتبة الرابعة: أن تكون الثانية زائدة على الأولى، والثالثة زائدة على الثانية؛ قال في المثل السائر: وينبغي أن تكون في هذا الحالة زيادة الثالثة متميزة في الطول على الأولى والثانية أكثر من تميز الثانية على الأولى. ثم قال: فإذا كانت الأولى والثانية أربع لفظات أربع لفظات تكون الثالثة عشر لفظات أو إحدى عشر لفظة، ومثل له في حسن التوسل بقوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولداً * لقد جئتم شيئاً إداً * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً * أن دعوا للرحمن ولداً * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً} فالأولى من ثمان كلمات، والثانية من تسع، والثالثة من عشر، ومثل له في المثل السائر بقوله في وصف صديق: فقلت: الصديق من لم يعتض عنك بخالف، ولم يعاملك معاملة الحالف، وإذا بلغته أذنه وشاية أقام عليها حد السارق أو القاذف؛ فالأولى: وهي لم يعتض عنك بخالف والثانية بعدها أربع كلمات، والثالثة عشر كلمات. ثم قال: وينبغي أن يكون ما يستعمل من هذا القبيل، فإن زادت الأولى والثانية على هذه العدة زادت الثالثة بالحساب، وإن نقصت الأولى والثانية، فكذلك. لكن قد ضبط في حسن التوسل الزيادة في الثالثة بألا تجاوز المثل، والأمر فيما بين الضابطين قريب؛ ولا يخفى حكم الرابعة في الزيادة مع الثالثة. قال في حسن التوسل: ولا بد من الزيادة في آخر القرائن.الغرض السادس فيما يكون فيه حسن السجع وقبحه أما حسنه، فيعتبر فيه بعد ما يقع فيكون به تحسين الكلام من أصناف البديع ونحوها بأمور أخرى:منها أن يكون السجع بريئاً من التكلف، خالياً من التعسف، محمولاً على ما يأتي به الطبع وتبديه الغريزة، ويكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى، بأن يقتصر من اللفظ على ما يحتاج إليه في المعنى دون الإتيان بزيادة أو نقص تدعو إليه ضرورة السجع، حتى لو حصلت زيادة أو نقص بسبب السجع دون المعنى، خرج السجع عن حيز المدح إلى حيز الدم.ومنها أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة، لاغثة ولا باردة، مونقة المعنى حسنة التركيب، غير قاصرة على صورة السجع الذي هو تواطؤ الفقر، فيكون كمن نقش أثواباً من الكرسف، أو نظم عقداً من الخرز الملون. قال في المثل السائر: وهذا مقام تزل عنه الأقدام، ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. قال: ومن أجل ذلك كان أربابه قليلاً، ولولا ذلك كان كل أديب سجاعاً، إذ ما منهم من أحد إلا وقد يتيسر عليه تأليف ألفاظ مسجوعة في الجملة.ومنها أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها، لأن اشتمال السجعتين على معنى واحد يمكن أن يكون في إحداهما بمفردها هو عين التطويل المذموم في الكلام، وهو الدلالة على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليه بدونها على ما هو مقرر في علم البيان. قال في المثل السائر: فلا يكون مثل قول الصابي في وصف مدبر: يسافر رأيه وهو دان لم ينزح، ويسير تدبيره وهو ثاو لم يبرح. ولو قال: يسافر رأيه وهو دان لم ينزح، ويثخن الجراح في عدوه وسيفه في الغمد لم يجرح، لسلم من هجنة التكرار، فإنه تصير كل سجعة محتوية على معنى بحياله. ومنها أن يقع التحسين في نفس الفواصل، كقولهم: إذا قلت الأنصار، كلت الأبصار؛ وقولهم: ما وراء الخلق الدميم، إلا الخلق الذميم، ونحو ذلك.ومنها أن يقع في خلال السجعة الطويلة قرائن قصار فتكون سجعاً في سجع، كقوله تعالى: {ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم} وقوله: {ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد} فإن قوله: {على أموالهم}. وقوله: {على قلوبهم} سجعتان داخلتان في السجعة التي آخرها {حتى يروا العذاب الأليم}. وقوله: {بآخذيه} وقوله: {يغمضوا فيه} سجعتان داخلتان في السجعة التي آخرها {غني حميد} وعد العسكري منه قولهم: عاد تعريضك تصريحاً، وتمريضك تصحيحاً.وأما قبحه فيعتبر بأمور: منها التجميع، وهو أن تكون فاصلة الجزء الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني كما حكى قدامة أن كاتباً كتب في جواب كتاب: وصل كتابك فوصل به ما يستعيد الحر، وإن كان قديم العبودية، ويستغرق الشكر، وإن كان سالف فضلك لم يبق شيئاً منه؛ فإن العبودية بعيدة عن مشاكلة منه.ومنها التطويل، فيما ذكر قدامة وغيره: وهو أن يجيء الجزء الأول طويلاً فيحتاج إلى إطالة الثاني بالضرورة، كما حكى قدامة أن كاتباً كتب في تعزية: إذا كان للمحزون في لقاء مثله كبير الراحة في العاجل، وكان طويل الحزن راتباً إذا رجع إلى الحقائق وغير زائل. قال في الصناعتين: وذلك أنه لما أطال الجزء الأول، وعلم أن الجزء الثاني ينبغي أن يكون مثله أو أطول، احتاج إلى تطويل الثاني فأتى باستكراه وتكلف. قال في مواد البيان: والإطالة بقوله وغير زائل.
|